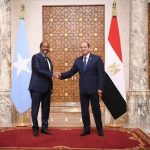انطلاقاً من التحوّلات التي مسّت سياقات القراءة، نجد أنفسنا أمام سؤال مركزي ونحن نقرأ كتاب “في مديح القارئ الأزرق”، مفاده إذا كانت وسائل التواصل حدّت من فعل القراءة، وهي في طريق القضاء عليه، فهل أنتجت هذه الوسائل قارئاً جديداً يمكن أن نسميه “القارئ الأزرق”؟
نجد الكثير من الإجابات النسبية في الكتاب عن ماذا ولماذا ومتى وكيف نقرأ، للباحث وأستاذ النقد المعاصر في جامعة بجاية الجزائرية، لونيس بن علي (1980)، من خلال تجربة شخصية للكاتب، ومن خلال الإشارة إلى كتب استطاعت أن تنتشل شخوصها من العبث والفراغ، بحيث يصبح الذهاب إليها شبيهاً بزيارة مدن تعلقنا بها وبسحرها.
نذكر من تلك العناوين “الكتب في حياتي” لهنري ميللر، و”الأدب في خطر” لتودوروف، و”حلم غاية ما” لكولن ولسون، و”كيف تقرأ ولماذا؟” لهارولد بلوم، و”مهنة القراءة” لبرنار بيفو، “وشخصيات مذهلة من عالم الأدب” لألبرتو مانغويل.
لكل كتاب ثمرة يجنيها قارؤه، وإن ثمرة كتاب “في مديح القارئ الأزرق”، هي أن يفكّر القارىء في إنشاء مكتبة خاصة، إن لم تكن ورقية، مثلما كان سائداً في السابق، فإلكترونية مثلما يوفره الحاضر.
عصابات القرّاء
يقول لونيس بن علي: “عام 1894 ألقى بول فاليري محاضرة في جامعة أوكسفورد، عن الموسيقى والأدب، جاء فيها: “جئتكم بنبأ،من أكثر الأنباء إثارة للدهشة، لم يحدث مثله من قبل. لقد عبثوا بقوانين الشعر”.
وقياساً على صرخة فاليري، يصرخ الكاتب بشكل ما: “لقد عبثوا بقوانين القراءة”.
ينبّه الكتاب إلى المنابع التي يمكن أن تخلق شغف القراءة في الإنسان، وإلى كيفية رعاية ذلك الشغف، حتى يصبح عادة ومساراً، وإلى كيفية انتقاء ما يُقرأ، ذلك أن القراءة العشوائية تضرّ أكثر مما تنفع، بالموازاة مع التنبيه، إلى حماية فعل القراءة من التحولات التي أفرزتها الروح الاستهلاكية، بصفتها ثمرة هي الأخرى، لاستسلام الإنسان المعاصر لمخالب المادة.
ومما ورد في الكتاب، “أن القارئ الحقيقي هو الذي يُنتج القراءة، ونظراً لندرة هؤلاء القرّاء، أصبحت القراءة هي الأخرى نادرة. فلا تغرّنك إذاً كثرة القرّاء الحشود بثرثراتهم وصخبهم الذي غزا العالم الافتراضي، والذي أصبح يهدّد المركز الذي كان يتمتّع به النقّاد، بوصفهم يُشكّلون نُخباً هادية”.
يضيف: “صعد نجم القرّاء في وقت أصبح فيه النقّاد كائنات ليلية تتخفّى في أماكن العتمة، وهؤلاء القرّاء صنعتهم أوهام ” الدمقرطة ” التي فرضتها بذكاء لا يخفي خبثه، وسائل التواصل الاجتماعي، فصرنا نرى عصابات من القرّاء تلقي بالأحجار على الكُتّاب الكِبار، من دون خجل، ومن دون شعور بالإثم. وكل يوم نرى إخلالاً بموازين الذوق العام، كما نرى إضراراً بقيمة الأدب”.
يرى الكاتب أنه “لم يعد هناك وجود للقارئ الذي يتلذّذ بالكلمات، وفي المقابل هناك قارئ يتلذّذ بعثرات النصوص؛ الأوّل عاشق، والثاني سادي. إن القرّاء اليوم يقرأون بمنظور الفراغ الذي يعانون منه؛ فيقومون بإسقاط انفعالاتهم النفسية، وغيضهم الدفين على النصوص”.
سيرة القراءة
يرى المؤلف “أن القارئ الأزرق الحقيقي، ليس ذلك الذي يدفن نفسه في مواقع التواصل، حتى إنه قد يضر بعينيه، من غير أن يكسب رؤية أو يمنحها، بل هو ذلك الذي تصبح القراءة لديه فعلاً حميمياً وإنسانياً، يجعل من الكتب كائنات حيّة تترتب عن العلاقة بها حقوق وواجبات”.
يطرح صاحب الكتاب عباءة الناقد، ويقترح نفسه قارئاً ينشر انطباعاته في “فيسبوك”، أي في الفضاء نفسه الذي ميّع القراءة والقارئ معاً، فيأخذ عنوان الكتاب معناه من تجربته الشخصية نفسها.
وإذا كان بول أوستر قال حين كتب مذكراته “اختراع العزلة”، إنه تبرّع بسيرته للناس، حتى يستفيدوا من تجاربه الخاصة، تبرّع لونيس بنعلي في هذا الكتاب، بسيرة القراءة لديه، بما يشكل تحريضاً جمالياً وفلسفياً، على أن تكون العلاقة بالكتب روحية، تقوم على الإدمان لا على المزاج، فتصبح شطراً من السيرة الذاتية للشخص.
تعود هذه العلاقة الروحية بالكتاب، لدى صاحب كتاب “تفاحة البربري”، إلى استغلال مرضه صغيراً، في قراءة رواية بوليسية أميركية، في زمن كان سالماً من امتصاص مواقع التواصل لأوقات روّادها، وحتى القنوات التلفزيونية لم تكن متاحة. يسأل: “هل شفيت بسبب الأدوية التي وصفها لي الطبيب، أم بسبب قراءة تلك الرواية الساحرة”.
الكتب والمشاعر
يقارن لونيس بن علي بين طلاب الأمس واليوم، في علاقتهم بالقراءة، فيذكر السعادة التي ملأت وجدانه، حين أهداه أستاذه الشاعر حميد بوحبيب رواية “الجريمة والعقاب” لفيدور ديستوفسكي، فتعامل مع صفحاتها السبعمئة بصفتها وجبة دسمة، كان يتجنّب أن تنتهي، بينما يشمئز طالب اليوم حين يكلّفه بقراءة رواية من 200 صفحة، “كأنني كلفته بحفر طريق في البحر المتوسط”.
يعترف صاحب كتاب “إدوارد سعيد: من خطاب الاستشراق إلى نقد الرواية الكولونيالية”، أن قراءة رواية دويستيفسكي شكّلت لحظة تحوّل كبيرة في حياته كقارئ، وأحدثت زلزالاً في نظرته للأدب. يقول: “ما أصابني بسبب تلك الرواية كان لعنة بالمعنى الفكري والجمالي للكلمة”.
وكي يتجنّب الكاتب تهمة التعاطي الرومانسي مع مسألة القراءة، يختم بالقول إنه ليس مثالياً، حتى يقول إن الكتب وحدها كافية لإزاحة كل البؤس الذي أثقل العالم، لكنها قادرة على محاربة المشاعر السلبية التي تأكلنا من الداخل.